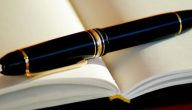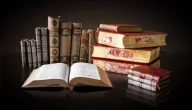سمات الادب في العصر المملوكي تميز بتأثره بالأوضاع السياسية والاجتماعية، حيث كان يعكس حالة التدهور والاضطراب في تلك الفترة. ومع ذلك، شهد تنوعًا في فنونه، مثل المقامات والشعر الشعبي، مع ازدهار أدب المديح والتاريخ.
محتويات المقال
سمات الادب في العصر المملوكي

- الاهتمام بالتكلف والمحسنات البديعية:
ركز الأدباء على الزخرفة اللفظية، واستخدام السجع والجناس والتورية، مما جعل النصوص أحيانًا تفقد عمقها الإبداعي لصالح الشكل الجمالي. - ازدهار الشعر الشعبي:
انتشر الزجل والموشحات والشعر العامي، حيث أصبح وسيلة للتعبير عن الحياة اليومية والقضايا الاجتماعية. - غلبة موضوعات المديح والرثاء:
تميز الأدب بتناول موضوعات مثل مدح الحكام والقادة ورثاء الشخصيات البارزة، مع قلة الاهتمام بالتجديد في الأفكار. - ظهور أدب التأريخ:
تأثرت النصوص الأدبية بالظروف السياسية، فبرزت المؤلفات التي توثق الأحداث التاريخية، مع دمجها أحيانًا بالأدب القصصي. - التأثر بالأزمات الاجتماعية والسياسية:
عكس الأدب حالة التدهور السياسي والصراعات بين المماليك، مما أدى إلى طابع سوداوي في كثير من الأعمال. - ظهور المقامات:
استمر انتشار فن المقامات، مع استخدام اللغة الفصحى في إطار قصصي مليء بالعبر والمواعظ. - ضعف الابتكار الأدبي:
طغت النزعة التقليدية والمحاكاة على الأدب، حيث قلّت محاولات التجديد والإبداع بسبب تراجع الحياة الثقافية.
أسباب ضعف الأدب في عصر المماليك

- الاضطرابات السياسية والاجتماعية:
أدى الصراع بين المماليك أنفسهم والانشغال بالحروب والغزوات، خاصة مع التهديدات الخارجية مثل المغول والصليبيين، إلى تدهور الحياة الثقافية وضعف الأدب. - تراجع الاهتمام بالعلوم والثقافة:
ركز المماليك على الجوانب العسكرية والإدارية على حساب دعم الحركة الفكرية والأدبية، مما قلل من رعاية الأدباء والعلماء. - غياب الإبداع والتقليد:
انشغل الأدباء بتقليد الأساليب القديمة والتركيز على الزخرفة اللفظية والمحسنات البديعية بدلاً من تطوير مضامين جديدة وإبداعية. - انتشار الأمية:
أدى تراجع التعليم وانخفاض نسبة المتعلمين إلى محدودية الجمهور المهتم بالأدب، مما أثر سلبًا على الإنتاج الأدبي. - تأثير الأزمات الاقتصادية:
أضعفت الأزمات الاقتصادية المستمرة الحركة الثقافية، حيث عانى الأدباء من قلة الموارد التي تمكنهم من الإبداع والتفرغ للأدب. - هيمنة الشعر على النثر:
رغم ازدهار بعض أنواع النثر كالمقامات والتاريخ، إلا أن سيطرة الشعر المديحي والاحتفالي على المشهد الأدبي حد من التنوع والإبداع. - انتشار الأدب الشعبي:
مع تراجع الاهتمام بالأدب الفصيح، ازدهر الأدب الشعبي كالزجل والموشحات، الذي كان موجهًا للطبقات العامة، على حساب الأدب الراقي. - ضعف التشجيع والرعاية:
قلَّت مجالس الأدباء وتراجعت الرعاية الرسمية من السلاطين والمماليك، ما أدى إلى إهمال تطوير الحركة الأدبية.
ما هي خصائص الشعر في العصر المملوكي؟
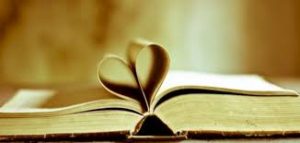
- الاهتمام بالمحسنات البديعية والزخرفة اللفظية:
ركز الشعراء على استخدام السجع والجناس والتورية والمقابلة، مما جعل الشكل الفني يغلب أحيانًا على المضمون. - غلبة موضوعات المدح والرثاء:
كان المدح، خاصة للحكام والقادة المماليك، والرثاء من أكثر الموضوعات شيوعًا، بالإضافة إلى الفخر والتهاني. - التقليد وضعف الابتكار:
قلَّ التجديد في الشعر، حيث اعتمد الشعراء على تقليد الشعراء القدامى في الأسلوب والموضوعات دون تقديم إبداعات جديدة. - انتشار الشعر الشعبي:
ازدهرت أنواع من الشعر الشعبي مثل الزجل والموشحات والدوبيت، التي كانت أكثر قربًا من عامة الناس. - تأثر الشعر بالظروف السياسية والاجتماعية:
عكس الشعر حالة التدهور والانقسامات التي شهدها العصر، مما أضفى طابعًا سوداويًا على بعض الأعمال. - ظهور الطابع التعليمي والمواعظ:
اتجه بعض الشعراء إلى تضمين الحكم والمواعظ في أشعارهم لتعليم الناس وإرشادهم. - الطابع الاحتفالي:
ظهرت في هذا العصر قصائد احتفالية تمجد المناسبات العامة والخاصة، مثل الأعياد والانتصارات. - الإكثار من الصور البيانية:
استخدم الشعراء التشبيهات والاستعارات بكثرة، مع اهتمام خاص بتعقيد الصور والرموز. - النزعة الدينية:
كان للدين حضور واضح في الشعر، سواء في المديح النبوي أو في قصائد الزهد والتصوف. - بساطة الألفاظ أحيانًا:
مع تطور الشعر الشعبي، بدأت الألفاظ تميل إلى البساطة والابتعاد عن التعقيد، لجعلها أقرب إلى فهم عامة الناس.
شعراء العصر المملوكي

- البوصيري (608-695 هـ / 1213-1296 م):
شاعر المديح النبوي الأشهر، اشتهر بقصيدته “البردة”، التي تعد من أعظم المدائح النبوية وأكثرها تأثيرًا. - ابن نباتة المصري (686-768 هـ / 1287-1366 م):
شاعر غزير الإنتاج، عُرف ببلاغته واستخدامه المكثف للمحسنات البديعية، وله ديوان ضخم يشمل مختلف الأغراض الشعرية. - ابن حجة الحموي (767-837 هـ / 1366-1433 م):
شاعر متميز بالزخرفة اللفظية، ألّف كتاب “خزانة الأدب” الذي يعتبر من أبرز كتب النقد والشعر في عصره. - ابن مليك الحموي (توفي 707 هـ / 1307 م):
شاعر غلب على شعره الطابع الديني، حيث كتب في الزهد والمدائح النبوية، بالإضافة إلى الوصف. - صلاح الدين الصفدي (696-764 هـ / 1296-1363 م):
شاعر وأديب ومؤرخ، امتاز شعره بالجمال اللفظي والدقة في التعبير، وكتب في موضوعات متنوعة. - ابن الوردي (691-749 هـ / 1292-1349 م):
شاعر ومؤرخ شهير، عُرف بقصيدته الزهدية “نصيحة الإخوان” التي تحتوي على حكم ومواعظ. - السراج الوراق (668-736 هـ / 1269-1335 م):
شاعر شعبي اشتهر بالزجل والموشحات، وقد تميز شعره بالبساطة والتعبير عن حياة عامة الناس. - ابن منظور (630-711 هـ / 1232-1311 م):
على الرغم من شهرته كصاحب معجم لسان العرب، كانت له إسهامات شعرية تظهر براعته الأدبية.